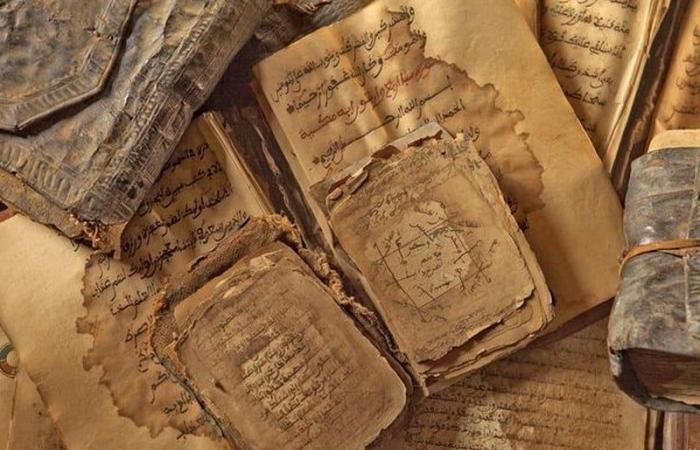تشكل بعض الأفكار بطبيعتها البنيوية العصية على التبسيط والاختزال تحديًا حقيقيًا أمام آليات الاستهلاك الثقافي السريع. هذه الأفكار لا تتناسب، في عمقها وتشعب تفاصيلها الضرورية، مع الإيقاع المتسارع للبرامج الحوارية، ولا تنسجم مع منطق القوالب الجاهزة التي تسعى لحشر المعرفة في كبسولات سريعة الهضم. إن هذه الأفكار العميقة لا يليق بها، في حقيقة الأمر، إلا بطء القراءة التأملية العميقة في كتاب محكم البناء، أو تفصيل التحليل الدقيق في مقال مطوّل يتيح لها المساحة الكافية للنمو والتجذر والتفصيل كما يجب.
حين نحاول، مع ذلك، إخضاع هذه الأفكار المعقدة لمنطق البرامج الحوارية وقيودها الزمنية الصارمة، فإننا نخاطر بخنقها في المهد، وحرمانها من الفضاء الطبيعي الذي تحتاجه للتنفس والازدهار. فمهما ادّعت تلك البرامج من احترافية عالية وتخصص دقيق، يظل إيقاعها المتسارع وقيدها الزمني المفروض عائقًا بنيويًا أمام تقديم أي فكرة جوهرية بكامل أبعادها المتشعبة وتفاصيلها اللازمة للفهم الحقيقي. في أفضل الأحوال، تأتي النتيجة مبتورةً ومُخلّة، تشوه الفكرة أكثر مما تخدمها، وفي أسوئها، يتحول الأمر إلى عملية تضليل صريحة تحت غطاء المعرفة والتنوير.
للأسف الشديد، هذا بالضبط ما انطبق على حلقة “في الاستشراق” من بودكاست ياسين عدنان، التي استضافت د. أحمد شحلان، الفينومينولوجي المغربي، المتخصص في اللغات الشرقية. هذه الحلقة، رغم تميز البرنامج الواضح والمشهود في حلقات سابقة متعددة، وحرفية مقدمه ووعيه الثقافي، لم تسمح للأفكار العميقة والمثيرة التي طرحها ضيفه، د. شحلان، بأن تصل إلينا مكتملة ومتماسكة كما يجب. ولأنه ليس بين يدي، للأسف، أي كتاب منشور لـ د. شحلان يمكن الرجوع إليه كمرجع أساسي، يبقى من الصعب الجزم بشكل قاطع بما إذا كان ما ورد في الحلقة يمثل كامل أطروحته الفكرية وأبحاثه، أم أنه مجرد ومضات سطحية وعابرة لم تسمح لها طبيعة البرنامج الحواري المقيدة بالزمن بالتفصيل والنضج كما تستحق.
الفخ الأيديولوجي
قدم د. شحلان في بداية الحلقة اعتراضًا وجيهًا ومنطقيًا على تسمية “اللغات السامية”، مشيرًا بحق إلى خلفيتها الأيديولوجية والدينية الواضحة التي ربطت، بشكل اعتباطي وغير علمي، اللغات بالنسب الأسطوري إلى سام بن نوح. هذا النقد، في حد ذاته، يدل على وعي نقدي حقيقي وقدرة على تفكيك الأسس الأيديولوجية التي تختبئ وراء التصنيفات العلمية المزعومة. لكن د. شحلان، في اقتراحه البديل الذي يقدمه، وهو تفضيل شخصي في نهاية المطاف، لا يبتعد هو نفسه عن الوقوع في فخ الأيديولوجيا المقابلة والمناقضة، إذ يقترح تسمية “اللغات العُربانية”، مؤسسًا طرحه هذا على فرضية أن الجزيرة العربية هي أصل تلكم اللغات وأصل شعوب بلاد ما بين النهرين، وأن “العربية” هي اللغة الأم والأصل التاريخي لهذه الشجرة اللغوية بأكملها، ومُعليًا من شأنها ومكانتها على حساب اللغات الأخرى، خاصة العبرية التي يختزلها إلى مجرد لهجة تفتقد الإعراب النحوي ولا ترقى، بالتالي، لمستوى اللغة الأم الحقيقية.
هنا يطرح السؤال الجوهري والمحوري نفسه بإلحاح: عن أي “عربية” تحديدًا يتحدث د. شحلان؟ هل يقصد عربية القرآن الكريم (وبالتالي عربية الشعر الجاهلي)؟ أم أنه يشير إلى نسخة أقدم، أولية ومفترضة، تمثل أصلًا أولًا ونقيًا للغة لم تصلنا نصوص مكتوبة منه؟
قِدم العربية: حقائق أثرية مقابل أوهام قومية
إن الحديث عن اللغة العربية باعتبارها كيانًا واحدًا ومتجانسًا عبر التاريخ يشكل، في حد ذاته، تبسيطًا مخلًا للواقع اللغوي المعقد في شبه الجزيرة العربية. فالاكتشافات الأثرية والنقوش المكتشفة في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة تؤكد وجود تنوع لغوي هائل وثري، حيث تحدثت القبائل العربية القديمة بلغات ولهجات متعددة ومتمايزة، منها اللحيانية التي انتشرت في شمال الحجاز وأجزاء من الأردن الحالي، والثمودية التي وجدت نقوشها في مناطق واسعة من شبه الجزيرة، والصفائية التي تركزت في البادية الأردنية والسورية، والنبطية التي هيمنت على التجارة والحضارة في جنوب الأردن وشمال السعودية.
هذه اللغات، التي يطلق عليها علماء اللغة “العربيات القديمة” أو “اللغات العربية الشمالية القديمة”، تختلف كثيرا عن العربية الفصحى التي نعرفها اليوم، سواء في نظامها الصوتي أو في تراكيبها النحوية أو في معجمها.
إن العربية الفصحى التي نعرفها، والتي نقلت إلينا الشعر الجاهلي (مع التحفظ على التسمية) والقرآن الكريم، تمثل في الواقع تطورًا لاحقًا نسبيًا، نتج عن عملية طويلة وممتدة من التفاعل والاندماج بين هذه اللهجات واللغات العربية المتنوعة. هذه اللغة الفصحى كانت على الأرجح لغة أدبية موحدة تطورت بين قبائل شبه الجزيرة العربية، ولم تظهر بشكلها المكتمل إلا في فترة متأخرة نسبيًا مقارنة باللغات السامية الأخرى. هذه العملية، التي يمكن تسميتها التوحيد اللغوي لتسهيل تبادل الإنتاج الأدبي الشعري، حدثت تدريجيًا عبر قرون، وتسارعت بشكل كبير مع ظهور الإسلام والحاجة إلى لغة موحدة للتدوين والإدارة والتجارة عبر المساحات الواسعة التي دخلت تحت الحكم الإسلامي.
إن القول بأن “عربية القرآن” هي أصل اللغات السامية يتناقض، بشكل صارخ ومباشر، مع كل ما أثبتته الدراسات اللغوية المقارنة والاكتشافات الأثرية من أن العربية الفصحى هي لغة حديثة نسبيًا ضمن هذه العائلة اللغوية. سبقتها لغات أخرى من عائلة “العربيات القديمة” ومن لغات أخرى من الشجرة الموصوفة باللغات السامية.
التناقض العلمي والانحياز الأيديولوجي
يجادل د. شحلان، في سياق تقليله من شأن العبرية، بأن التوراة لم تُكتب أصلًا بالعبرية، متجاهلًا التعقيدات التاريخية والنصية لهذه المسألة. لكن هذا الجدل الأيديولوجي يتناقض، بشكل صارخ ومحرج، مع المعرفة العلمية الدقيقة والعميقة التي يفصح عنها هو نفسه في الحلقة دون أن يدرك التناقض الذي يقع فيه. فهو يدرك تمامًا، ويعترف بوضوح، أنه لا وجود تاريخي حقيقي لكتاب وحي منزل اسمه “التوراة” بالمعنى الذي يتصوره العامة. يقرّ د. شحلان، بصراحة علمية لا لبس فيها، بأن ما قد يُعتبر وحيًا منزلًا فعليًا على النبي موسى لا يتجاوز في أفضل الأحوال بضع كلمات مقدسة هي الوصايا العشر، بل ويذهب إلى افتراض أنها كُتبت باللغة المصرية القديمة، مبررًا ذلك بأن موسى كان مصريًا بالتربية والثقافة ولا يعرف إلا المصرية والعربية بحكم احتكاكه بأهل مدين (وهنا نعود مرة أخرى للسؤال المحوري: أي “عربية” بالضبط يقصد د. شحلان؟)
أما نصوص وأسفار العهد القديم، كما هي موجودة عندنا اليوم، فهي نصوص بشرية بامتياز، كُتبت بالعبرية في مراحل تاريخية متأخرة نسبيًا، بعد الفترة التي تسميها السردية اليهودية “السبي البابلي”، وهي متأثرة كثيرا بنصوص حضارات بلاد ما بين النهرين، بعضها منقول حرفيا مثل قصة الطوفان وشريعة حمورابي، وبعضها أعيد صياغتها لتناسب السردية اليهودية.
إن امتلاك معرفة دقيقة ونقدية كهذه، معرفة قادرة على تفكيك الأساطير التأسيسية وتعرية الادعاءات المقدسة، كان من الأجدى والأنسب أن تقود باحثًا بحجم د. شحلان وعمق اطلاعه، مع إلمامه باللغات القديمة، إلى مستوى فكري آخر، أكثر تقدمًا وتعقيدًا، يتجاوز به سطحية المفاضلة القومية بين اللغات وأصولها المزعومة، ويرتقي به إلى مساءلة أعمق للمسلمات الحضارية والثقافية. لكنه، للأسف الشديد، اختار أن يسجن نفسه وفكره داخل أسوار فكرية معينة، تمامًا كما فعل المعتزلة من قبله.
المعتزلة: أسوار الاجتهاد العقلي
إن مقارنة موقف د. شحلان بموقف المعتزلة التاريخي ليست مقارنة عابرة أو عارضة، بل تكشف عن نمط فكري متكرر في الثقافة العربية والإسلامية، نمط يتميز بالجرأة الجزئية والتراجع عند العتبات الحاسمة. فعلى الرغم من ثورتهم العقلانية غير المسبوقة في الفكر الإسلامي، وجرأتهم في استخدام العقل كأداة لفهم النصوص الدينية، لم يجرؤ المعتزلة على المضي في مسارهم العقلاني إلى نهايته المنطقية، ولم يتجرؤوا على مساءلة كل المسلمات بنفس الدرجة من النقد والتفكيك. بدلًا من ذلك، انطلقوا من بدهيات ومسلمات معينة اعتبروها غير قابلة للنقاش أو المساءلة، ثم قضوا عمرهم الفكري في بناء تأويلات معقدة وتبريرات ملتوية لحماية هذه المسلمات من نتائج التفكير العقلي، بدلًا من ترك العقل يذهب في مساره المنطقي الطبيعي إلى نهاياته الحتمية، مهما كانت مؤلمة أو مزعجة للثوابت الموروثة.
ربما وحده ابن الراوندي تجرأ على تجاوز عتبة الهدم الحقيقي والمساءلة الجذرية دون تراجع أو مساومة، لكنه، للأسف، توقف عند مرحلة الهدم والتفكيك وانشغل بالهجوم (والدفاع) ضد المعتزلة دون أن يقدم نظريته المعرفية البديلة.
وهكذا، يبدو أن د. شحلان، وهو يمتلك بوضوح أدوات التفكيك النقدي والمعرفة العلمية اللازمة، يفضل، لأسباب أيديولوجية (قومية ودينية)، استخدام هذه الأدوات لإعادة بناء أسطورة قومية جديدة، بدلًا من توظيفها في مشروع تحرري حقيقي. فيخرج المستمع العادي، غير المتخصص في هذه المسائل، من حلقته بقناعة غير صحيحة مفادها أن “عربية القرآن” هي لغة قديمة ومقدسة، تسمو على العبرية وغيرها من اللغات، وأنها الأصل التاريخي والحضاري الذي تفرعت عنه اللغات “السامية” الأخرى.
هذه الفكرة تتناقض بشكل مباشر وصارخ مع كل ما أثبتته الدراسات اللغوية المقارنة الحديثة والاكتشافات الأثرية المتراكمة عبر العقود، من أن العربية الفصحى التي نعرفها اليوم، أي لغة القرآن ولغة الشعر الجاهلي، هي لغة حديثة نسبيًا ضمن شجرة اللغات المعقدة التي تجمع حزمة واسعة ومتنوعة من اللغات التي تحدث بها العرب الأقدمون عبر قرون طويلة، مثل اللحيانية والثمودية والصفائية والنبطية وغيرها من اللغات التي تختلف كثيرا عن العربية الفصحى في بنيتها وتراكيبها ومفرداتها.
الدرس الإسرائيلي في إحياء اللغة
عرض د. شحلان في ختام الحلقة نقطة مضيئة وجوهرية تستحق الوقوف عندها، حين تحدث عن الكيفية الذكية والمنهجية التي اعتنت بها الحركة الصهيونية، ثم دولة إسرائيل لاحقًا، باللغة العبرية الحديثة، لتُحوّلها، عبر جهد مؤسسي ومجتمعي منظم، من لغة شبه ميتة ومحصورة في النصوص الدينية القديمة إلى لغة حية ونابضة قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وإنتاج الفكر والأدب المعاصر، رغم قلة عدد المتحدثين بها.
هذه ملاحظة ثمينة ومهمة يجب أن نقف عندها طويلًا ونتعلم منها، فنحن اليوم في أمسّ الحاجة للاعتناء الجدي والمنهجي بلغتنا العربية وتطويرها وتحديثها، ليس انطلاقًا من أوهام الأفضلية العرقية أو ادعاءات الأسبقية التاريخية الخرافية، بل من وعي حقيقي وعملي بأن اللغة هي هويتنا الباقية والأساسية، وحصننا الأخير والأهم في مواجهة عالم يحفل بالتحولات الجذرية والتحديات الحضارية الكبرى.
إن الثقافة العربية اليوم، للأسف الشديد، تعيش في الحضيض الحضاري والفكري، رغم أن اللغة العربية تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد المتحدثين بها كلغة أم، وهي اللغة الأكثر انتشارًا من عائلة اللغات “السامية” إن كان لنا أن نشغل أنفسنا بهذا التصنيف الذي لا يقدم ولا يؤخر في معركة النهضة الحقيقية.
المعركة الحقيقية والملحة اليوم ليست معركة إثبات أي اللغات أفضل أو أقرب إلى المقدس، وليست انشغالًا عقيمًا بالبحث عن لغة أهل الجنة أو لغة آدم الأسطورية، بل هي معركة الحاضر والمستقبل، معركة البقاء الحضاري. مهمتنا الحقيقية والملحة ليست الركون الكسول إلى أمجاد الماضي، حقيقية كانت أم متوهمة ومتخيلة، بل هي الرقي الفعلي بلغتنا وثقافتنا، وتأسيس بنية تحتية علمية وفكرية رصينة ومعاصرة تسمح لهذه اللغة بأن تكون أداة حقيقية وفعالة للنهضة والتقدم والمساهمة في الحضارة الإنسانية.
ملاحظة أخيرة: لا أقلل أبدا من شأن البحث في أصل اللغات، وتشابكها مع بعض والبحث في التمييز بينها، وبالضرورة لا أتجاهل الأهمية الكبيرة لفقه اللغة، بل أرى أن جزئية “المفاضلة” بين اللغات أمر عبثي لا فائدة منه، ولا يفعل إلا إعادتنا إلى الخطابات الأصولية المغلقة التي تنشغل بنواقض الوضوء ولغة أهل الجنة.
الخلاصة، بصيغة أخرى أكثر وضوحًا ومباشرة: لا يهم، في نهاية المطاف، بأي لغة “نزلت” التوراة، العبرية أم العربية، والصراع بين من يعتبر العربية لغة أهل الجنة ومن يرى أنها العبرية، بل الأهم والأجدى هو كيف نرقى بلغتنا العربية اليوم، وكيف ننتج بها العلم والفكر والأدب والفلسفة، وكيف نجعلها قادرة على التعبير عن تعقيدات العصر ومتطلباته، حتى نتوقف عن هذا الانحدار المستمر والمتسارع نحو هاوية التخلف الحضاري التي نقترب، يومًا بعد يوم، من الوصول إلى عمقها السحيق.
هذا هو التحدي الحقيقي، وهذه هي المعركة التي تستحق أن نخوضها بكل قوانا وإمكاناتنا، وفقه اللغة (تخصص د. شحلان) هي واحدة من تلك الآليات التي نحتاج أن نملكها.