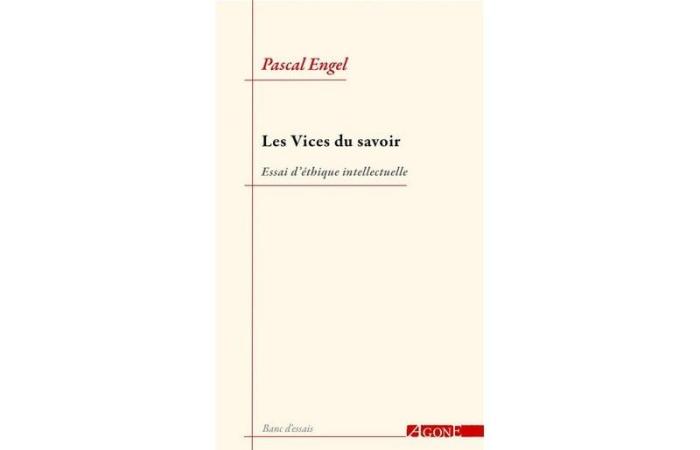ليس كتاب “رذائل المعرفة” (Les vices du savoir) لباسكال إنجل (Pascal Engel) مجرد درس في الفلسفة، إنه صفْعة فكرية لكل من يظن أنه يملك الحقيقة لمجرد أنه يُجيد الكلام. بهذا المعنى أعتبر هذا الكتاب مرآة تُجبرنا على التحديق في هشاشتنا المعرفية، لا لنزدريها، وإنما لنفهم كيف تتحوّل المعرفة إلى تواطؤ، والذكاء إلى مَكيدة، والاعتقاد إلى وسيلة للهيمنة؛ ولهذا فإن كل من يتصدر المنابر، أو يتحكّم في الموارد، أو يوجّه الرأي، أو يُكوِّن العُقول، مَعنيٌّ بقراءته: السياسي والإعلامي، رجل المال وسيدة الأعمال، الأستاذ والمعلم، الباحث والمثقف… فالرذائل المعرفية لا تفرّق بين سلطة الخطاب وسلطة المال وسلطة التعليم. إن قراءة هذا الكتاب ليست رفاهًا فكريًا، بقدر ما هي ضرورة أخلاقية، لأن من لا يفهم كيف يُضل الآخرين قد لا ينتبه متى صار ضحية تضليله الخاص.
حين يفشل العقل في أخلاقه
يتضمن العنوان الفرعي لكتاب “رذائل المعرفة”، الموسوم بـ”بحث في الأحكام الأخلاقية الفكرية”، أطروحة مفادها أن الاعتقاد ليس فعلاً معرفياً صرفاً، بقدر ما هو نشاط محكوم بمعايير أخلاقية تضبط العلاقة بين الذات والموضوع، بين العقل والواجب، وبين الإدراك والتزامه. بهذا لا تصبحُ القيمة المعرفية للاعتقاد قائمة على مطابقته للواقع فقط، وإنما على مدى استحقاقه الأخلاقي، واتساقه مع فضائل عقلية مثل الإنصاف، والاتساق الداخلي، والتواضع الفكري.
تستعيد هذه الأطروحة، وإن لم تكن جديدة عن التفكير الفلسفي، راهنيتها ضمن السياق المعرفي المعاصر، الذي يشهد تضخماً في الإنتاج المعلوماتي وتراجعاً في ملكة التمييز؛ فالمعرفة أضحتْ تُقاس بقدرتها على مقاومة الانفعالات، والاختزال، والتسطيح. في هذا السياق يطرح كتاب رذائل المعرفة تساؤلاً محورياً: كيف نميز بين الخطأ المعرفي والرذيلة المعرفية؟ أي بين الزلل الناتج عن نقص المعطيات والانحراف العقلي الناتج عن إخلال أخلاقي في التقدير أو الاستدلال؟.
وعلى هذا النحو لا تقتصر الرذيلة المعرفية على المغالطات أو سوء الفهم، ذلك أنها تُجسِّد تهاوناً في أداء الواجب العقلي. فالتسرّع في إصدار الأحكام، والتشبث باليقينيات، واللامبالاة بالمراجعة، تمثل إخفاقات فكرية ذات طبيعة أخلاقية، لأنها تُغلق إمكانات المراجعة، وتحول دون نشوء حوار عقلاني. وعليه تُعدّ المعايير الأخلاقية مكوِّناً بنيوياً في شروط الاعتقاد المعقول، لا مجرد عناصر خارجية طارئة تُضاف إليه من خارج نسقه المعرفي.
يمكن القول، بنوع من التّعْميم، إن مساءلة البنية الوجدانية للاعتقاد تتضمن في الجوهر بعض العناصر اللاعقلانية التي تهيمن على الفضاء المعرفي، مثل الغرور المعرفي، والحسد، والرغبة في الهيمنة الرمزية. وهذه الانفعالات، وإن بدت شخصية أو هامشية، تُنتج آثاراً بنيوية، لأنها تتحول إلى أنماط استقبال تُحدِث خللاً في المجال العمومي، وتُضعف شروط التواصل العقلاني. وفي هذا الإطار تصبح محاربة الرذائل المعرفية مسألة ذات طابع مدني، لأنها تُمَسّ أسس التعاقد الديمقراطي، وتتطلب مجهوداً جماعياً لتثبيت فضائل فكرية، مثل المساءلة، والانفتاح، والتريث.
أخذا بالاعتبار ما سلف يمكن القول إن المعرفة، على الأقل كما تصورها باسكال إنجل في تحليله، ليست مجرد محتوى قابل للاكتساب، بقدر ما هي علاقة مركبة تفترض التزاماً ذاتياً ومساءلة دائمة. ومن ثم فمقاومة الرذائل الفكرية تقتضي تربية عقلية تُعيد الاعتبار للبطء، وللتفكير التأملي، وللصمت بوصفه شرطاً للإنصات، وللشك بوصفه أداة للفهم.
إن أكبر تهديد يواجه المعرفة اليوم ليس الجهل المحض، وإنما تراكم الضجيج الذي يخلط بين المعلومة والرأي، وبين الانفعال والحكم. وكل مشروع ثقافي يروم تعزيز المعرفة لا بد أن يبدأ من مساءلة العلاقة بين الفضائل الفكرية والالتزام الأخلاقي، بوصفهما بنيتين متداخلتين تشكلان معاً شرعية الاعتقاد.
إذا كان الخطاب المعرفي التقليدي قد انشغل بمشكلة الحقيقة بما هي غاية للمعرفة فإن كتاب “رذائل المعرفة” يعيد فهم الحقيقة بمعزل عن الشروط الأخلاقية التي تجعل من طلب الحقيقة سلوكًا مشروعًا ومُستحقًا. بهذا يُحدث الكتاب نقلة من نظرية المعرفة إلى الأخلاق المعرفية، حيث لا يكفي أن يكون الاعتقاد صادقًا، بل ينبغي أن يكون صادقًا على نحو مبرَّر، وعن استحقاق؛ ولذلك لا يعدّ الاعتقاد الصحيح الناتج عن حدس أعمى، أو عن تقليد أخرس، سلوكًا معرفيًا فاضلًا، حتى وإن صادف الحقيقة. من هنا استخلاص التصورين التاليين:
الرذائل المعرفية نماذج إدراكية منحرفة، تتأسس على تشويه العلاقة بين الذات والآخر، وبين الفكر والسياق، وبين التجربة والمعنى.
الرذائل المعرفية نقائص على مستوى الأداء العقلي، ومواقف وجودية تتضمن أشكالًا من التمركز، والغرور، والكسل، والانعزال، ما يجعلها أنماطًا من العمى الأخلاقي المعرفي.
بهذا المعنى لا تُعدّ الرذائل المعرفية مجرد سمات فردية معزولة، لكنها تكتسب طابعًا ثقافيًا يتكرّس داخل البنيات الاجتماعية ومؤسسات التنشئة، إذ يُسهم النظام التعليمي القائم على الحفظ الآلي في إنتاج نمط من الجهل لا يقتصر على غياب المعرفة، بل يُشكّل نمطًا من الخضوع المعرفي، حيث يُطبع المتعلم على الاتكالية المعرفية ويُنمّي ميولًا إلى التلقي السلبي بدل الممارسة النقدية النشطة. ومن ثم تُصبح الرذائل المعرفية أدوات ثقافية لإعادة إنتاج الجهل وترسيخه، بدل أن تُفهم بوصفها مجرد إخفاقات ذاتية أو انحرافات فردية.
يتبيّن مما سبق أن مواجهة الرذائل المعرفية لا تقتصر على تحسين المحتوى المعرفي أو إثرائه، وإنما تقتضي، على نحو أعمق، إعادة بناء “الذات العارفة” بوصفها كيانًا أخلاقيًا مسؤولا؛ فالمعرفة لا تنفصل عن الموقف الأخلاقي، والاعتقاد لا يُعدّ حياديًا، لأنه ينطوي دائمًا على ادعاء ضمني بالمشروعية والاستحقاق، وقد يتوسّع ليشمل وهْم التفوّق. وإذا لم تُخضع هذه الادعاءات لمعيار أخلاقي ناقد فإنها تنقلب إلى أدوات للهيمنة الرمزية وممارسات تعالٍ اجتماعي، تُكرّس التفاوت بدل أن تُسهم في تقويضه.
يلفت باسكال إنجل الانتباه إلى أهمية “النية” في تبنّي الاعتقادات، وهي مسألة كثيرًا ما تغيب عن النقاشات المعرفية التي تكتفي بتحليل صدق المضمون أو انسجامه المنطقي. ذلك أن الرذيلة المعرفية لا تقتصر على ما يُقال، وإنما تشمل أيضًا لماذا يُقال وكيف يُقال. إذ إنّ الاعتقاد متى كان مشروطًا بدوافع غير نزيهة، كالسعي إلى الهيمنة أو التباهي أو مجرد المعارضة العدوانية للآخر، يغدو اعتقادًا منقوص الفضيلة، فاقدًا لأسسه الأخلاقية. من هنا يُطرح سؤال أخلاقي جدير بالاعتبار: هل يظل الاعتقاد نزيهًا عندما يتحوّل إلى وسيلة لتحقيق غايات تتعلق بالهيمنة أو النفوذ؟ يتفرّع عن هذا سؤال آخر: ما العلاقة بين الرذائل المعرفية والهوية؟ فبعض الرذائل، كالعناد أو التعصب، تتغذى من الإحساس بالانتماء، أو من الحاجة إلى حماية صورة الذات. بهذا المعنى تغدو الرذيلة فعلًا دفاعيًا ينطوي على رهانات سيكولوجية. ومن ثَمّ تصبح مهمة التربية المعرفية مزدوجة: تنقية أدوات التفكير، وتفكيك أوهام الهوية.
من الشك الأخلاقي إلى الزيف المؤسسي
ثمة علاقة ملتبسة بين الشك والرذيلة؛ ليس الشك دومًا فضيلة، حين يتحوّل إلى تشكيك منهجي يعادل بين جميع الآراء، ويفكك كل مرجعية، يُفضي إلى النسبية المطلقة أو إلى اللامبالاة. لذلك بالإمكان التفريق بين شك فاضل يُحفّز التفكير، وشك رديء يُقوّض شروط المعقولية، مثلما يُفرّق بين الثقة المبررة والثقة العمياء.
ثمّة بعد مهم آخر يوليه باسكال إنجل أهمية بالغة ألا وهو العلاقة بين الرذائل المعرفية والعنف الرمزي؛ فحين يتشبث المرء بيقينياته دون استعداد للحوار يتحوّل إلى أداة قمع معرفي، حتى وإن لم يمارس عنفًا مباشرًا. اللامبالاة برأي الآخر، ورفض الاعتراف بالخطأ، واستعمال اللغة للإخضاع، كلها أشكال من العنف الذي تغذيه الرذيلة.
وفي مواجهة هذا الانزلاق المعرفي والأخلاقي لا يكفي الاقتصار على التنديد الخطابي بالرذائل، بل تبرز الحاجة إلى هندسة شروط مؤسساتية حاضنة للفضائل الفكرية. ذلك أن ترسيخ النزاهة المعرفية يستدعي بيئة تشجّع التساؤل بدل التلقين، وتكافئ الدقة بدل الإثارة، وتمنح الكلمة لمن يُحسن الإصغاء بقدر من يُجيد الخطاب. يتطلب الأمر مناهج تربوية تُنمّي الفكر النقدي، وإعلامًا لا يلهث خلف الاستهلاك السريع للآراء، ونقاشًا عموميًا قائمًا على التواضع المعرفي، لا على استعراض المواقف.
بكلمة جامعة نحن بحاجة إلى سياسة معرفية متبصّرة تُنظّم شروط إنتاج الاعتقاد الفاضل، وتُحصّن الفضاء العمومي ضد التفاهة والتضليل.
هل يمكن فهم الرذائل المعرفية على أنها مجرد أخطاء معرفية معزولة، أم إنها تكشف، في العمق، عن خلل في تحمل المسؤولية الفكرية والأخلاقية؟ أليست هذه الرذائل، في جوهرها، تعبيرًا عن عزوفٍ عن إقامة علاقة صادقة مع الحقيقة، ومع الذات، ومع الآخر؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يكفي تصحيح المعلومات لمواجهتها أم إن المطلوب هو بناء أخلاقي لذاتٍ منفتحة، ومستعدة للمساءلة؟ ثم ألا يُصبح التصدي للرذائل المعرفية شرطًا ضروريًا للعيش المشترك، من حيث هو توافق سياسي، ونمط من الالتزام بالإنصات والاحترام والتواضع؟ وأخيرًا ما الذي يتبقى من التفاهم الإنساني حين تُهمَل هذه الفضائل، ويُستعاض عنها بالادعاء والتعالي واللامبالاة؟.
إذا كانت السلطة تُعرَّف تقليديًا بأنها القدرة على التأثير فإن الرذائل المعرفية تتحوّل إلى أدوات غير معلَنة لممارستها؛ فحين يُشيع المتكلم خطابًا مبنيًا على الادعاء دون دليل، أو على التأويل المغلق دون قابلية للنقاش، فإنه يُمارس سلطة ناعمة تُخضِع المتلقي عبر ما يُشبه المعرفة، لكنه في العمق يُنتج جهلاً مقنّعًا.
تندرج ضمن هذا الأفق ما يُسميها باسكال إنجل “الاعتقادات المريحة”، وهي تلك التصورات التي يعتنقها الأفراد أو الجماعات لا باعتبارها مؤسَّسة على حجج معرفية رصينة، وإنما لكونها توفّر لهم قدرًا من الاستقرار النفسي وتمنحهم شعورًا بالتماسك الهوياتي. وبهذا تجد الرذائل المعرفية سبيلها إلى التنكر في هيئة الحكمة، ويغدو الوهم قادرًا على ارتداء ملامح البصيرة.
تبرز رذيلة “التفاهة”بوصفها أحد أشكال الاستقالة المعرفية التي تفضي إلى اختزال التعقيد والعمق الفكري في شعارات مبتذلة ومبسطة، تُكرّس ثقافة السطحية بدلًا من التفكير النقدي والتحليل الدقيق. ففي سياق هذه الرذيلة يتحول التفكير إلى مجرد تكرار آلي لأفكار رائجة لا تستند إلى بحث أو تدقيق، كما يُحتفى بالأقوال الفارغة والسطحية بوصفها معانيَ عميقة وجذابة. يفضي هذا المناخ الفكري إلى عزوف الفرد عن مجابهة التحديات المعرفية، ويعمّق حالة الركود الذهني، حيث يغدو التجاوب مع الأفكار العميقة والاستقصاء النقدي أمرًا نادرًا أو مرفوضًا، ما ينعكس سلبًا على جودة الخطاب الفكري والثقافي ويُضعف قدرة المجتمع على الإنتاج المعرفي الأصيل. وبالتالي فإن التفاهة لا تمثل مجرد ضعف في المحتوى، بل هي مؤشّر على أزمة أعمق في الموقف تجاه المعرفة والجهد الذهني.
تتقاطع رذيلة “التبرير” بشكل وثيق مع رذيلة “التفاهة”، إذ تمثل انحرافًا جوهريًا في وظيفة العقل؛ ففي هذا السياق لا يُوظَّف العقل باعتباره وسيلة لاكتشاف الحقيقة أو نقد الأفكار، وإنما يُستغل لخدمة مواقف مسبقة والدفاع عنها من غير تمحيص. يتحول العقل من كونه قاضيًا محايدًا إلى محامٍ ملتزم يُبرر ويُسوِّغ الوضع القائم، بغض النظر عن مدى عدالته أو عقلانيته. يُولّد هذا الاستخدام المزيف للعقلانية معرفة زائفة ترتزق بالتكيّف مع الهياكل القائمة، وتغلفها بحُجج مزيفة ترفض النقد والتغيير. ومن ثَم فإن التبرير لا يُضعف فقط من نزاهة الفكر، بقدر ما يساهم في استدامة أنظمة جائرة وغير عقلانية، مجمدًا حركة التطور الفكري والاجتماعي، ومقيدًا إمكانية التحول والتجديد.
أما رذيلة “السطحية” فهي الوجه الإدراكي لـ”التفاهة”، حيث تُبنى الأحكام على انطباعات عابرة، ويتم تداول المعرفة بوصفها سلعة سريعة الاستهلاك، غير قابلة للتعمّق أو التأمل. في ظل ثقافة التواصل اللحظي يصبح عمق الفكرة عائقًا أمام انتشارها، ويغدو التفكير البطيء علامة ضعف. هكذا تتحوّل “السطحية” من عرض هامشي إلى أسلوب حياة، ومن اختزال مؤقت إلى معيار للنجاعة.
أخيرا، يربط باسكال إنجل بين هذه الرذائل والمناخ السياسي، حين يتمّ تفضيل الشخصيات الكاريزمية على المثقفة، والخطابات الحماسية على التحليلات المعقدة، والمواقف الجذرية على المواقف المتأنية. الرذيلة المعرفية هنا تخدم إستراتيجيات الهيمنة، إذ توفّر لجمهورٍ واسع أحكامًا جاهزة، ومواقف مبسطة، وتُجنّبه عناء التساؤل.
ومن بين الرذائل المعرفية المراوغة يبرز ما يُعرف بـ«الاستعراض المعرفي»، حيث تُستثمر المعرفة لا باعتبارها أداة للفهم أو مدخلًا إلى الحوار البنّاء، بل كوسيلة لإنتاج التفوق الرمزي وفرض الهيمنة. في هذا السياق لا يكون غرض المتكلم إقناع الآخر بالحجة أو إثراء النقاش، بل احتكاره، عبر استعراضٍ معرفي يُقصي الاختلاف ويُخفي عجزًا عن الإنصات المنتج. هكذا يتحول خطاب المعرفة إلى مسرح تُعرض فيه قدرات المتحدث على التنظير والاحتواء الرمزي، ما يعزز الفجوات الاجتماعية والثقافية بدلاً من تجاوزها. وهذا الاستعمال الانتهازي للمعرفة يُضعف من قيمتها الحقيقية كوسيلة للتواصل والتبادل، ويحول الفكر إلى أداة للسلطة لا للتنوير، ما يعوق التقدم الفكري ويكرّس التوترات الاجتماعية القائمة.
تشكل رذيلة “الأنانية المعرفية” إحدى تجليات الانغلاق الفكري، حيث تغدو الذات العارفة محكومة برغبة عميقة في الاحتفاظ بالسلطة على الحقيقة، رافضةً الإنصات أو الاحتكام إلى النقد. هذه الرذيلة تنحو إلى تحجيم الفهم وتضييق آفاق المعرفة، إذ ترى أن الحقيقة لا تتعدى حدود رؤيتها الخاصة، ما يحول الحوار إلى مجرد استعراض للذات، لا إلى تبادل حقيقي للأفكار. وتتجلى هذه الأنانية في التعالي الثقافي والاجتماعي على مصادر المعرفة المتنوعة، فتصبح الذات العارفة سلطة مطلقة غير قابلة للمساءلة أو النقاش، وهو ما يؤدي إلى تقويض الدينامية الفكرية وتجميد الإبداع المعرفي.
من الرذائل التي تستدعي وقفة تأملية خاصة ما يمكن تسميتها “الرغبة في التصديق غير المشروط”، وهي حالة معرفية لا تنبع من نقص الأدلة بقدر ما تعبر عن هشاشة أخلاقية أمام الحاجة إلى الاطمئنان. لا تكمن هذه الرذيلة في الجهل، وإنما في إغفال الواجب المعرفي للشك، حين يوظّفُ التصديق بوصفه تعويضا وجوديا لا اختيارا معرفيا. إنها خيانة مزدوجة: خيانة للحقيقة، وخيانة للذات المفكّرة.
في المقابل تبدو “الثرثرة” كأنها رذيلة بريئة، لا تُثير قلقًا معرفيًا للوهلة الأولى، لكن خطرها الحقيقي يكمن في تمييع المعنى عبر فرط التداول، وتحويل الكلمة من أداة للفهم إلى ضوضاء لفظية. ليست الثرثرة فعلاً يُدمّر الحقيقة بقدر ما يُخدّرها؛ إنها شكل من أشكال النسيان المعرفي، لا مجرد جهل بها؛ ففي فضائها يغيب التمييز بين القول ومضمونه، ويُستعاض عن التفكير الحيّ بتواصل يخلو من العمق ويُنكر الحاجة إلى المعنى. لذلك تصبح هذه الرذيلة أكثر حضورًا في بيئة تحكمها وسائط التواصل الفوري، حين يُعاد إنتاج المعرفة في شكل شذرات لا سياق لها. الثرثرة، في هذا السياق، ليست فقط كثرة الكلام، إنها تقطيع للمعنى وتفتيت للتركيز، وهو ما يجعل العقل المعاصر عرضة لفقدان الانتباه المعرفي، أي العجز عن بناء مسار فكري متماسك.
كيف السبيل لمحاربة كل هذه الرذائل المعرفية وغيرها؟
ما أصبح في حكم المؤكد أن محاربة هذه الرذائل وغيرها لن يتمّ عبر النقد، لأنه لم يعدْ مجديا ولا فائدة مرجوة منه. ولعلّ ذلك يكون ممكنا من خلال: إرساء بيئة حوارية تُشجّع على الفضائل، مثل التواضع المعرفي، والكرم التأويلي، والانفتاح على الغيرية؛ إذ لا تُزهر الفضائل الفكرية في الفراغ، بل تحتاج إلى بيئة ثقافية حاضنة ترعى نموّها، وإلى شروط حوارية تؤسس لإمكان تحققها؛ فبدون هذا الإطار الحواري والمناخ القيمي تغدو الفضيلة الفكرية مجرّد نزعة معزولة بلا أثر فعلي.
يشكّل هذا النوع من الرذائل المعرفية خلفية لكثير من أشكال التعصب الثقافي أو الإيديولوجي، حيث يُختزل المعنى في وجهة نظر واحدة، وتُشيطَن جميع البدائل. وعوض أن يكون اليقين ثمرة بحث طويل يُصبح نقطة انطلاق مغلقة لا مجال فيها للمراجعة.
ها هنا يتهاوى أهم أركان النزاهة المعرفية: قابلية الاعتقاد للاختبار والنقد.
نحو فلسفة أخلاقية للذهن
يستلزم تفكيك الرذائل المعرفية، من غير شك، يقظة أخلاقية حقيقية تجاه أدوارنا في الفضاء المعرفي، باعتبار أن ما يبدو انحرافًا فرديًا في توظيف المعرفة غالبًا ما ينطوي على أثر يتجاوز الذات ليُخلّف أضرارًا ملموسة في محيطه الإنساني. فالرذيلة المعرفية، كما تبين من عرضي السابق، ليست مجرد خلل في النية أو ضعف في أدوات الفهم، بل هي ممارسة تُسيء إلى الآخر، سواء عبر التضليل المتعمد، أو الإقصاء الرمزي، أو الإغواء الخطابي، أو اجترار المعاني بشكل فارغ ومنزوع الدلالة؛ لذلك فإن تقييم المعرفة لا يمكن أن يُختزل في معيار الصدق أو الصواب المنطقي فحسب، وإنما يتعيّن أن يُؤطر كذلك بأثرها الأخلاقي والاجتماعي، أي بقدرتها على الإسهام في بناء فضاء معرفي عادل، مسؤول، وقابل للتشارك.
ما يُميز هذا التصور أن الرذيلة المعرفية تحاربُ بالقدرة على مقاومة إغواء الراحة، والسلطة، والانتماء، والانفعال؛ أي إنها تقاوم عبر بناء أخلاقي للفكر.
مازال الدافع الكامن وراء سعينا المعرفي موضع تساؤلٍ أنطولوجيٍّ وأخلاقيٍّ في آنٍ معًا: أتُحرّكنا رغبةٌ أصيلةٌ في اقتناص الحقيقة بصفتها قيمةً قائمةً بذاتها أم إنّنا نتطلّع من خلال المعرفة إلى الضمان والطمأنينة، فنستعيض بها عن هشاشتنا الوجوديّة؟ أَنُحاول، عبر الفهم، أن نفتح العالم على تعقيداته وتضاريسه المتشابكة، أم إنّنا نتوسّل إدراكه وسيلةً لتثبيت حضورنا الرمزي وإثبات ذواتنا في فضائه؟ يشي هذا الارتباط المحكم بين الحقيقة والأمان، وبين الفهم والاعتراف، بأنّ المعرفة تتحوّل إلى مجال تتداخل فيه الرغبات والمصالح والهواجس الوجوديّة، فتغدو أداةً مزدوجة: إمّا لبناء فهمٍ نقديٍّ متحرّر، وإمّا لتشييد حصونٍ نفسيّةٍ تُحصّن الذات من قلق المجهول.
تتجاوز هذه الأسئلة وسواها حقل المعرفة، لتطال البنية العاطفية والأنطولوجية للعقل الإنساني، بما هو عقل هش، ومتورط في أهوائه، ومفتوح، رغم ذلك، على إمكان التَّطهّر من رذائله.
لنتأمل؛ وإلى حديث آخر.