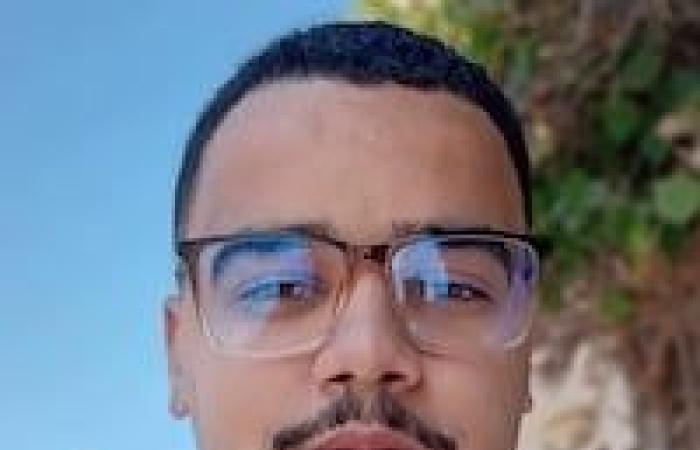مقدمة :
تُعَدُّ رواية حاجب السلطان لصلاح الدين أقرقر، الصادرة عن المركز الثقافي العربي سنة 2025، خامس أعماله الروائية، ومحطته البارزة في اقتحام أفق الرواية التاريخية المغربية. يستعيد الكاتب عبرها التاريخ المحلي في صيغة تخييلية تمزج بين المرجعية الواقعية وحساسية البناء الجمالي للسرد. ويغدو النص، في جوهره، مختبرًا سرديًا لاختبار طاقات اللغة حين تتقاطع مع الموروث، في أبعاده الدينية والشعرية، عبر استدعاء مكثف للمتون القرآنية والأحاديث النبوية وأصداء الشعر الكلاسيكي. بهذا الانفتاح، تتحول الرواية إلى فضاء حواري يتقاطع فيه الماضي مع الحاضر، ويلتقي فيه النص التراثي بالسرد المعاصر، في جدلية تُعيد إنتاج المعنى وتنعش الذاكرة.فكيف يوظف أقرقر المتن الديني والشعري في روايته؟ وهل يحضر هذا التراث كسلطة مهيمنة على السرد، أم كأداة سردية خاضعة لإعادة التشكيل و التوظيف؟
تندرج دراسة توظيف المتن الديني والشعري في رواية حاجب السلطان ضمن حقل الدراسات السردية التي تعنى بعلاقة النصوص الروائية بالتراث، باعتباره أحد المكونات البارزة في البناء الجمالي والدلالي للأعمال الأدبية في الثقافة العربية. و يُقصد بالـمتن – وفق الاستخدام النقدي – كل نص أصيل أو ثابت في الذاكرة الثقافية، يستحضر داخل نص آخر عبر الاقتباس المباشر أو التضمين أو الإحالة غير المباشرة. ويمثل المتن الديني، هنا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أو الإشارات ذات المرجعية العقائدية، بينما يشمل المتن الشعري الأبيات الشعرية الموروثة، سواء من الشعر العربي الكلاسيكي القديم أو الأندلسي …، التي تُستدعى لتأدية وظيفة جمالية أو دلالية أو حجاجية.
ويُعدّ التراث – كما عرفه محمد عابد الجابري – “مجمل ما خلفه الأسلاف من إنتاج فكري وروحي، في مجالات الدين واللغة والأدب والفلسفة، مما يشكل رصيدًا ثقافيًا للأمة”. هذا التراث، حين يُستحضر في الرواية، يمارس سلطة النص، أي قدرته على إنتاج المعنى وتوجيه التأويل. غير أن هذه السلطة لا تكون مطلقة دائمًا، إذ يمكن للسرد المعاصر أن يُعيد تأويل هذا التراث أو تفكيكه وفق مقتضيات الحبكة وأهدافها الجمالية. أما مفهوم سلطة السرد فينطلق من التصور الباختيني لمبدأ “تعدد الأصوات”، حيث لا يكون النص المقتبَس مجرد عنصر خارجي يُضاف إلى الرواية، بل يدخل في حوار حيّ مع أصوات الشخصيات والسارد، فتتوزع السلطة بين النص التراثي والنص الروائي³. وبهذا المعنى، يصبح إدماج المتون الدينية والشعرية في الرواية فعلًا حواريًا، يُعيد تشكيل هذه المتون داخل سياق جديد، يختلف عن سياقها الأصلي، دون أن يُفقدها طاقتها الرمزية أو المرجعية.
في ضوء هذا التصور، فإن تحليل حاجب السلطان يقتضي النظر إلى النصوص الدينية والشعرية المستحضَرة من زاويتين متكاملتين: الأولى، زاوية الذاكرة الثقافية، حيث تحضر هذه النصوص كجزء من هوية المجتمع وقيمه؛ والثانية، زاوية الوظيفة السردية، حيث تتحول إلى أدوات لبناء الشخصيات، وتعميق الأجواء الدرامية، وفتح الرواية على أفق تأويلي واسع يتجاوز حدود الحكاية إلى مجال الفكر والثقافة.

الغلاف كعتبة نصية
يعتبر الغلاف من أحد أجزاء البناء المعماري النصي، الذي يندرج في ما يسميه جيرار جنيت بـالعتبات النصية..
الصورة: لوحة مائية لفرسان مغاربة بلباس تقليدي، على صهوات خيول، بألوان تتراوح بين الأبيض والأحمر و الترابي. الرسم غير مكتمل التفاصيل، وكأنه يترك للمخيال مهمة الإتمام.
الدلالة: الفارس والخيل رمزان للسلطة والتنقل و الصراع. عدم اكتمال الرسم يوازي عدم اكتمال السرد التاريخي داخل النص، حيث يظل جزء من الحقيقة معلقًا بين المروي والمسكوت عنه.
الكتابة: العنوان بخط عريض أحمر يوحي بالقوة وربما الدم.
العنوان: “حاجب السلطان” يحيل تاريخيًا إلى منصب رفيع في البلاط المغربي والأندلسي، يتمتع صاحبه بسلطة تنظيم شؤون القصر والتحكم في الوصول إلى الحاكم. رمزيًا، يمثل العنوان صورة الباب المغلق والوسيط بين السلطة والعامة، بما يحمله من دلالات الهيبة والسرية. سرديًا، يهيئ العنوان القارئ لولوج نص يتقاطع مع التاريخ السلطاني، ويشتغل على تفكيك بنية السلطة، حيث يصبح “الحاجب” ليس مجرد شخصية تاريخية، بل رمزًا للتحكم في الحقيقة والرواية نفسها
تجليات المتن الديني في الرواية
يَحضر المتن الديني في الرواية بوصفه رافعةً دلالية وأخلاقية ؛ يستدعى القرآن والحديث لتأطير الوعي السردي، وضبط موقف الشخصيات من الذنب والهداية، ومنح الخطاب السردي سلطة معرفية تعلو على الذات المتكلمة. حين يُدرَج النصّ المقدّس داخل السياق الحكائي، فإنه يعيد ترتيب سلّم القيم ويحوّل التأمل الداخلي إلى التزام معياري يُحاسَب عليه السارد/الشخصية.
نجد على سبيل المثال قوله تعالى “بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه”(القيامة،14-15) يأتي في لحظة سرديةتعكس صراع الشخصية مع نوازعها الداخلية ومقاومة الشهوات، وهو توظيف يضفي على النص سلطة خطابية عالية تستند إلى المرجعية الدينية، فيضع المتلقي أمام موقف أخلاقي حاسم. الآية هنا لا تعمل كمجرد زينة بل تشتبك مع السياق النفسي للشخصية، لتؤكد فكرة الوعي الذاتي بالذنب واستحالة التنصل من المسؤولية حتى مع محاولة التبرير. إدراج النص القرآني داخل السرد يعمّق المعنى ويكثّف البعد الوعظي، كما يربط التجربة الفردية بمرجع ديني يفرض ثقله المعرفي والقيمي على الموقف، مما يمنح السرد قوة إقناعية وامتدادا روحيًا يتجاوز اللحظة الحكائية
وفي هذا مشهد اخر ، يصف أقرقر رجلاً يقوم بفعلٍ عمليٍّ مباشر في الحمام (سحب سطلين من قمة الصرح والعودة بهما) دون أن يتبادل أي كلمة مع السارد. هنا يأتي إدراج الآية الكريمة «لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»(التين،4) بوصفه مفارقة ساخرة؛ إذ يوظف النص المرجع القرآني الذي يصف كمال الخلق الإلهي، في سياق يبرز النقص الإنساني على مستوى التواصل والسلوك الاجتماعي. بهذا، يتحول الاقتباس القرآني من مجرد إقرار بعظمة الخلق إلى أداة نقدية تكشف الفجوة بين الكمال البنيوي الذي منح للإنسان، وبين قصوره أو امتناعه عن توظيف هذه النعمة في التفاعل الإنساني. هذا الاستخدام يعكس مهارة أقرقر في تطويع المتن الديني ليخدم بعدًا سرديًا ساخرًا وناقدًا في آن واحد
يحضر النص القرآني في الرواية بكثافة واعية، ويتم توظيفه في محطات سردية محددة، تتصل بلحظات التحوّل، كالموت، التوبة، الزهد، أو الصراع الداخلي للشخصيات و كذلك لتثبيت المعنى ومنحه بعدا أخلاقيًا وروحيًا، أو لإسناد مواقف الشخصيات وتوجيه مسار الأحداث، أو حتى لخلق مفارقة دلالية حين تُدرج في سياق مغاير لمعناها المألوف. هذا الحضور الكثيف يجعل المتن الديني جزءًا أصيلًا من النسيج الحكائي، تتجاور فيه سلطة التراث، بما تحمله من يقين وقداسة، مع سلطة السرد التي تعيد تأويله وتطويعه لخدمة البنية الفنية للرواية
تجليات المتن الشعري في الرواية
المتن الشعري، بما يحمله من إيقاع وبلاغة وتكثيف دلالي، يمثل في العمل الروائي المعاصر أكثر من مجرد اقتباس أو استدعاء جمالي؛ فهو مخزون ثقافي يُستثمر لفتح النص على فضاءات التراث، وإغنائه بطبقات من المعنى تتجاوز حدود السرد المباشر. وحين يُدرج داخل الرواية، فإنه لا يأتي معزولًا عن سياق الحكاية، بل يتشابك معها ليعمّق الدلالة، ويعكس رؤية الشخصيات وعلاقتها باللغة والهوية، فيتحول إلى مكوّن عضوي في البنية السردية، لا عنصرًا زخرفيًا هامشيًا.
مثلا في مشهد تعلّق الشخصية بعلوم النحو والأدب، يستدعي الكاتب أبياتًا تحثّ على طلب العلم بدءًا بالنحو: “العِلمُ شيءٌ حسنٌ** فكن له ذا طلبٍ / بالنحو فابتدِئ وخذ **من بعده في الأدب”(تنسب لمحمد بن يحيى الأصاريفي) هذا الاستدعاء يخدم بناء الشخصية وكذلك إبراز أن البناء المعرفي للشخصية يبدأ من إتقان اللغة، ويؤسس لرؤية تجعل التراث اللغوي أساس الهوية الثقافية.
وفي موضع آخر، يستحضر أبيات امرئ القيس التي ترسم صورة مكثفة للاغتراب الإنساني: “أجارتَنا إنَّ الخطوبَ تنوبُ**//
///**وكلُّ غريبٍ للغريبِ نسيبُه”(امرؤ القيس) هذا التوظيف الشعري يؤدي وظيفة مزدوجة؛ فهو أولًا يرسّخ الجو النفسي للشخصيات عبر استحضار إحساس الاغتراب والتباعد العاطفي، مما يمنح السرد بعدًا وجدانيًا عميقًا يختصر بكثافة شعورية ما قد يتطلب صفحات من السرد النثري. وثانيًا، يربط النص بالحقل الثقافي العربي الكلاسيكي، حيث يتحول الشعر إلى أداة للتعبير عن مشترك إنساني خالد — الغربة — لكنه يكتسب خصوصيته داخل الرواية حين يوضع في سياق تفاعل بين شخصيات معاصرة، فيخلق جسرًا بين الوجدان الفردي والتراث الجمعي.
أما في سياق الوعظ ومجاهدة النفس، فيلجأ إلى أبيات أبي الأسود الدؤلي ذات النفَس الأخلاقي الصارم: “لا تنهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثلَهُ // عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ” ليضفي على الموقف سلطة تراثية تُعزز البعد القيمي وتتماهى مع التحولات الداخلية للشخصية. ويأتي كذلك منسجما مع السياق السردي الذي يناقش فيه الراوي مسألة الأخلاق والتوبة ومجاهدة النفس. إدراج هذه الأبيات لا يعمل فقط على إسناد المعنى بنص تراثي ذي سلطة أخلاقية، بل يمنح الموقف عمقًا بلاغيًا يختصر الصراع الداخلي للشخصية(الطالب السوسي) في صيغة شعرية مكثفة. كما أن اختيار أبيات تحمل خطابًا وعظيًا مباشرًا يعكس نبرة النص في تلك اللحظة، ويجعل القارئ أمام تلاقٍ بين السرد الروائي والموروث الشعري بوصفه مرجعًا قيميًا وتعليميًا.
و بهذا التوظيف المتنوع، يجعل أقرقر المتن الشعري أداةً للتعميق الدلالي وتوسيع أفق النص، حيث يتحول الشعر إلى جسر بين التجربة الفردية والذاكرة الجمعية، وإلى وسيط جمالي ومعرفي يربط الحاضر بأصداء الماضي، ويثري السرد بطاقة إيقاعية ورمزية تعزز فرادته.
سلطة التراث وسلطة السرد – جدل التفاعل
في النصوص الأدبية، خاصة في الرواية العربية المعاصرة (حاجب السلطان نموذجا)، يتحرك الكاتب على أرض مزدوجة: أرض يرثها، تتمثل في التراث بمختلف أشكاله؛ الديني، والشعري، والشعبي، بما يحمله من سلطة رمزية ومرجعية أخلاقية وجمالية، وأرض يخلقها عبر الحكي والتخييل والبناء السردي الحديث، بما يمنحه من حرية في التشكيل وإعادة إنتاج المعنى.
من تداخل هاتين الأرضيتين، يتولد توتر خلاق بين قوتين متقابلتين: سلطة التراث، بما تمثله من خطاب ماضٍ مقدس أو راسخ يُستدعى في لحظات التأسيس والتأكيد والتفوق الأخلاقي، وسلطة السرد، بما تمثله من قدرة على إعادة تأويل ذلك التراث وتفكيكه، وترويضه داخل آلة الحكي . في حاجب السلطان، لا يَرِد التراث كإحالة مجانية، بل بوصفه قوة حاضرة وفاعلة، تمنح المشاهد عمقا رمزيًا وصلابة مرجعية، وتربط الحاضر بامتداداته الثقافية والتاريخية. غير أنّ السرد لا يقف موقف الخضوع، بل يستوعب هذا التراث، ويعيد تشكيله في بنية حكائية حيّة، قادرة على نزع قداسة المعنى الواحد، وفتح مسارب جديدة لقراءته. في لحظات، يعلو صوت التراث كصوت يقيني يزكي الحاضر ويؤطره، وفي لحظات أخرى، يعلو صوت السرد، فيحوّل النصوص الموروثة إلى أدوات للتفكيك، أو للمفارقة، أو لإضاءة البعد النفسي والوجودي للحكاية. بهذا المعنى، تتحول الرواية إلى فضاء تفاوض دائم بين قوتين: إحداهما تمنح النص جذوره ورسوخه، والأخرى تمنحه حيويته وقدرته على الانفتاح. فلا التراث يبقى معزولًا في برجه، ولا السرد يتنكر لجذوره، بل يلتقيان في نقطة وسطى، حيث يُحفظ للتراث سلطته، ويُمنح للسرد حقه في الحرية وإعادة الخلق. والنتيجة نص غني، متشظٍّ بالمعاني، وفيٌّ لماضيه، ومتمرّد عليه في آن واحد.
خاتمة:
إن رواية حاجب السلطان تكشف عن وعي جمالي وتاريخي في التعامل مع التراث، حيث يصبح النص الديني والشعري أداة للحوار بين الماضي والحاضر، بين سلطة الذاكرة وسلطة الحكاية. هذه القدرة على المزاوجة بين الإسناد التراثي والانفتاح السردي تجعل الرواية نموذجًا بَارزا في الكتابة التاريخية التخييليّة بالمغرب.