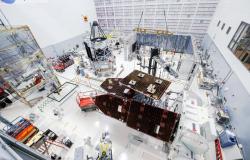من بين جميع الدول الغربية، لم يكن لصوت الاعتراف بدولة فلسطين أن يحمل ما يحمله من دلالات لو لم يصدر عن فرنسا. فباريس ليست مجرد عاصمة دبلوماسية عريقة، بل هي البلد الذي يقف على خط التماس بين سرديتين، وعلى أرضه تتقاطع ذاكرة الهولوكوست مع قصص الهجرة الإنسانية ومآسي اللجوء، وتعيش فيه أكبر جالية يهودية في أوروبا إلى جانب أكبر جالية مسلمة في القارة ذاتها.
وتحت هذا التناغم الهش، وفي هذا التاريخ المشحون، يكتسب الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وزنًا استثنائيًا، لا يُقاس بالأثر السياسي فحسب، بل بما يعنيه من كسر لصمت طويل فرضته المعادلات المعقدة داخل فرنسا وخارجها.
على مدى سنوات، حافظت باريس على موقف “النأي المتوازن” عن الانحياز الصريح لأي طرف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. خطاب رسمي يعلن دعم حل الدولتين، دون أن يخطو خطوة عملية نحو تمكينه.
لكن حرب غزة الأخيرة، وما خلّفته من دمار هائل ومجاعة جماعية، دفعت الضمير السياسي الفرنسي إلى لحظة مراجعة. وها هو الرئيس إيمانويل ماكرون يعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين رسميًا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، داعيا شركاءه الأوروبيين إلى الانضمام إلى هذا المسار.
خلفيات القرار الفرنسي لا تنفصل عن السياق الإقليمي والدولي الراهن. فالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة، وما خلّفته من دمار هائل، وضعت حلفاء إسرائيل الغربيين، لا سيما في أوروبا، تحت ضغط شعبي وأخلاقي متزايد، تجسّد في تراجع مستويات التأييد الشعبي لإسرائيل، وصعود الدعوات السياسية للاعتراف بالحقوق الفلسطينية كمدخل للتوازن والعدالة.
اللافت أن الخطوة الفرنسية جاءت بعد أكثر من عام على اعتراف ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين ضمن حدود ما قبل 1967. ورغم أن المبادرة حينها اعتُبرت ذات طابع رمزي، إلا أن إعلان باريس كسر هذا الانطباع، ودفع بالاعتراف إلى واجهة الفعل الدبلوماسي لدولة مؤثرة في القرار الأوروبي والعالمي.
فرنسا الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن، والراعية تقليديًا لمشاريع السلام الدولية، تتقدم اليوم بخطوة تبدو رمزية في ظاهرها، لكنها تحمل رسالة سياسية بالغة القوة. فحين تقول دولة بحجم فرنسا: “نحن نعترف بفلسطين”، فإنها تضع القضية من جديد في قلب المحافل الرسمية، لا باعتبارها نزاعًا إنسانيًا فقط، بل كقضية شرعية سياسية تستوجب الحسم.
ردود الفعل جاءت متوقعة: إسرائيل وصفت القرار بأنه “مكافأة للإرهاب”، والولايات المتحدة، التي يقودها دونالد ترامب في ولايته الثانية، قلّلت من أهمية الخطوة ورفضتها علنًا. ومع ذلك، فإن ما جرى كسر لمعادلة الهيمنة المطلقة على رواية الصراع. لم تعد الساحة الدولية تقف على طرف واحد من التاريخ.
بل إن تأثير الخطوة الفرنسية بدأ يتردد صداه في أوروبا نفسها. ففي بريطانيا، تجاوز عدد النواب المطالبين بالاعتراف بدولة فلسطين 220 نائبا من مختلف التيارات، بينهم نواب من الحزب الحاكم. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، لم يغيّر موقف حكومته رسميا، إلا أن نقاش الاعتراف بات حيويا ومفتوحا، ليس فقط في لندن، بل في برلين وبروكسل وبرن وأثينا ولشبونة وأوتاوا…
أما من الناحية الرمزية، فإن إعلان ماكرون يحمل دلالة أخرى بالغة التأثير. ففي دولة تتقاسم فيها الجالية اليهودية وجراحها التاريخية حضورًا متجذرًا في الثقافة والسياسة، إلى جانب جالية مسلمة تحمل في وعيها الجماعي ميراث النكبة والشتات، يكتسب الاعتراف معنى أعمق: إنه محاولة لإعادة التوازن الأخلاقي داخل البيت الفرنسي نفسه، قبل أن يكون خطابًا موجّهًا إلى الخارج.
لا يمكن فصل هذا الاعتراف عن سياق الحرب في غزة، ولا عن الغضب الشعبي الفرنسي المتصاعد حيال ما يجري. لكن الأهم من كل ذلك أن الخطوة تُعيد صياغة المعادلة: لم يعد الاعتراف بفلسطين ترفًا سياسيًا أو مجاملة رمزية، بل تحوّل إلى مسؤولية، وربما إلى واجب أخلاقي على الدول التي ما زالت تضع العدالة الدولية في قاموسها.
الاعتراف الفرنسي لن يغيّر موازين القوى على الأرض، لكنه يعيد كتابة التوازن في اللغة. اللغة التي طالما اختطفتها القوة لصالح طرف واحد. والأهم، أنه يفتح الباب أمام تحالفات جديدة، لا تقوم فقط على الجغرافيا والمصالح، بل على الوعي بأن الكرامة لا تُمنح، بل تُنتزع، وبأن الاعتراف لا يصنع الدولة وحده، لكنه يمنحها صوتًا مسموعًا في زمن ساد فيه الضجيج بلا مضمون.
وفي النهاية، فإن الاعتراف الفرنسي خطوة جريئة، لكنها ليست كافية. ما سيمنحها قيمتها الحقيقية، هو من سيجرؤ على أن يلحق بها.