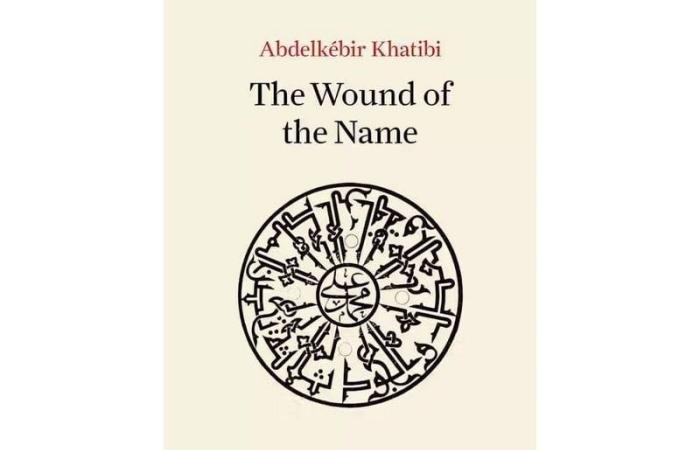عن منشورات جامعة نورثويسترن، صدرت باللغة الإنجليزية ترجمة “الاسم العربي الجريح” لعالم الاجتماع والإناسة والأديب المغربي عبد الكبير الخطيبي، الراحل سنة 2009.
هذه الترجمة الجديدة، الصادرة حديثا في صيغتَين ورقية وإلكترونية، بعد أزيد من خمسين سنة مذْ تاريخ النشر الأصلي للكتاب باللغة الفرنسية في 1974، نقلها إلى اللغة الإنجليزية مات ريك، وهو مترجم سبق أن تُوّجت ترجماته.
الكتاب الذي ترجمه إلى العربية محمد بنيس، يعرّف الناشر ترجمته الجديدة إلى الإنجليزية بأنها تهم “عملا كلاسيكيا للنظرية النقدية في شمال إفريقيا، يروم نزع الاستعمار في طرائق النظر والكتابة الفرنسية حول الثقافات المغاربية”.
وتابع التعريف: “كُتب هذا العمل خلال ذروة شعبية وحظوة السميوطيقا الفرنسية، فاقترح الخطيبي سيميوطيقا بينية كدراسة للعلامات التي تعبر جغرافيات ثقافية، وأزمنة، وتعبيرات، مرتبطة لكنها مختلفة”.
ووضّح التقديم أن عالم الكتاب هو أن الرموز ليست ثابتة، والمعنى ليس راكدا، سواء تعلّق الأمر بحِكَم، أو أوشام، أو بلاغة الجماع، أو الخطّ، أو المحكيات الشفهية، التي تُظهر معاني ثقافية تتداول عبر الحدود وضدّها ورغما عنها.
ويستمر الخطيبي، وفق الورقة التقديمية، في منهجه “النقد المزدوج” الذي يقصد “إعادة تعريف لا الفهم الأوروبي فقط لثقافة شمال إفريقيا، بل أيضا الفهم الشمال إفريقي للذات، بتحريره من السلطة الأنثروبولوجية للحقبة الاستعمارية الحديثة، وكذلك من “النماذج الثيوقراطية المخفّفة” التي طبعت دول شمال إفريقيا ما بعد الاستعمارية”.
وفي تقديم النسخة العربية التي تعود إلى سنة 1980 من “الاسم العربي الجريح”، كتب المفكر والشاعر محمد بنيس: “هذا الكتاب في رأيي أهم ما كتبه الخطيبي إلى الآن في مجال البحث، ويقارن أهميته ‘كتاب الدم’ في مجال الإبداع”؛ فهو “كتاب يعيد قراءة الجسم العربي من خلال موروث الثقافة الشعبية المغربية بوعي نقدي، يعتمد بعدين أساسيين هما نقد المفهوم اللاهوتي للجسم العربي من ناحية، ونقد المقاربات الأثنولوجية التي تتعامل مع الثقافة الشعبية تعاملا خارجيا ومتعاليا من ناحية ثانية”؛ إنه “النقد المزدوج كما يسميه الخطيبي كل اطمئنان يجد نفسه هنا محاكما، يستقبله سؤال ما نطق به اللسان من قبل”.
ويردف بنيس: “هذه القراءة النقدية للجسم العربي تسعى لهدف مركزي، هو الفصل بين الجسم المفهومي والجسم الحقيقي، المعيش والملموس. إن الثقافة العربية تعاملت مع الجسم انطلاقا من المتعاليات التي قعّدت قراءتنا له وفق قوانين لاهوتية، تفرغ الجسم من حمولته التاريخية والذاتية. وهكذا أصبح الحديث عن الجسم الواقعي يمر عبر الحديث عن جسم آخر غريب عنه. وماذا منحتنا هذه القراءة المتعالية في نهاية التحليل، غير الوعي الشقي الذي لا قدرة له على رؤية الجسم في حالاته الواعية واللاواعية؟”.
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه سبق أن نقل الباحث المهتم بمنجز عبد الكبير الخطيبي، مراد الخطيبي، ما كتبه جاك دريدا حول ضرورة ترجمة هذا المفكر إلى الإنجليزية: “مثل كثيرين، أعتبرُ عبد الكبير الخطيبي كأحد أكبر كتّاب عصرنا وشعرائه ومفكّريه الناطقين باللغة الفرنسية، وآسف لأنّه لم ينل الدراسة التي يستحقها في البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية. يهمّني أن أشير إلى أنّ أعماله، المعترف بقيمتها بشكلٍ واسع في العالمين العربي والفرنكفوني، هي ابتكارٌ شعري هائل، وفي الوقت ذاته، تأمّلٌ نظري متين يرتبط، من بين موضوعات كثيرة، بإشكالية ازدواجية اللغة وازدواجية الثقافة. ما يصنعه الخطيبي باللغة الفرنسية، ما يمنحه إياها بترك بصمته فيها، يتعذّر فصله عما يحلله من هذه الحالة، في أبعادها اللغوية، طبعاً، ولكن أيضاً الثقافية، والدينية، والأنثروبولوجية، والسياسية”.